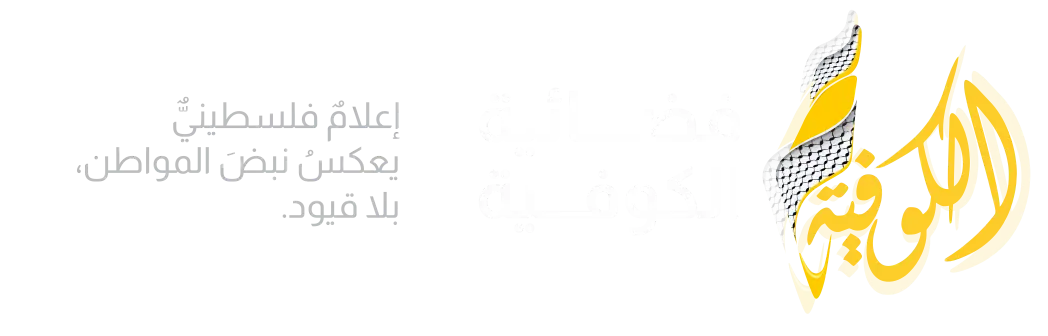أسطورة "طهارة" سلاح جيش الإحتلال !!
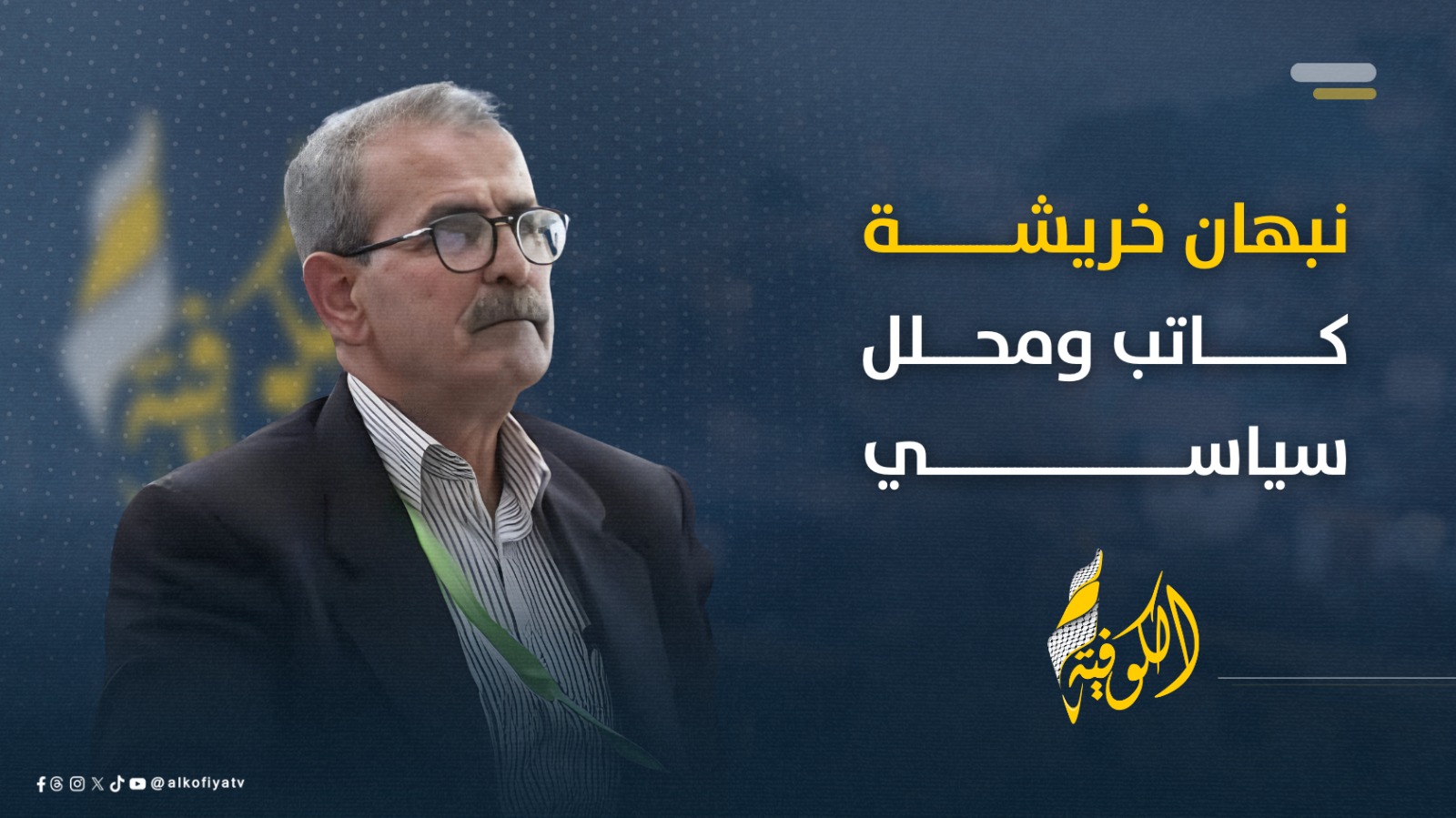
نبهان خريشة
أسطورة "طهارة" سلاح جيش الإحتلال !!
الكوفية مبدأ "طهارة السلاح" الذي يتبناه جيش الاحتلال الإسرائيلي ليس مجرد شعار أخلاقي يزين بيانات رسمية عسكرية، بل هو أسطورة مؤسسة تعمل كدرع معنوي يشرعن استخدام القوة ويخفف من وطأة المسؤولية السياسية والقانونية عن العنف الممارَس. منذ ولادة المشروع الصهيوني رافقته روايات أسطورية تأسيسية — أرض الميعاد، شعب الله المختار، "أرض بلا شعب لشعب بلا أرض" — وهي أساطير شكلت منطق الاستيطان والاقتلاع. وبين هذه الميتولوجيا، تبرز أسطورة "طهارة السلاح" كواحدة من أطرفها: فكرة أن جيشًا مسلحًا مكلفًا بإبادة وإخراج سكانٍ محليين يمكن أن يظل جيشًا "نظيفًا" أخلاقيًا، وأن استخدامه للسلاح يلتزم بقواعد الحرب وما يسمّى بالتمييز والضرورة العسكرية. لكن سجلات التاريخ المعاصر والوقائع اليومية تكشف تباينًا صارخًا بين القول والفعل، وتعرّي هذه الأسطورة في ضوء الأدلة والشهادات.
إن عقيدة جيش الإحتلال الإسرائيلي ترتكز على الأسطورة التوراتية المتعلقة بإقتحام "يهوشع بن نون" لمدينتي أريحا وحاصور الكنعانيتين باعتبارهما من أبرز مشاهد ما يسمى “غزو أرض كنعان” بعد وفاة النبي موسى. فبعد أن انهارت أسوار أريحا تلقائيًا نتيجة لأصوات الأبواق وصيحات "الشعب" سقطت المدينة دون قتال. عندها اقتحم الإسرائيليون المدينة وأبادوا كل من فيها، رجالًا ونساءً وأطفالًا وشيوخًا وحتى الحيوانات بحد السيف، وحرثوا ارضها بالملح. هذه الأسطورة توظفها الاوساط السياسية والعسكرية الإسرائيلية اليوم، باعتبارها نصا يبرر الغزو والإبادة وتفديس العنف باسم الدين، وتستعمل اليوم في بعض الخطابات الصهيونية كمرجع رمزي لتبرير السيطرة على فلسطين وتقتيل شعبها تحت غطاء ديني، تمامًا كما استخدمت قديمًا لتبرير الغزو الأول باسم الرب.
إن معظم الحروب والعمليات العسكرية التي شنتها إسرائيل ضد الفلسطينيين أو في المنطقة حملت أسماءً ذات دلالات توراتية واضحة، في تعبير صريح عن توظيف الأساطير الدينية لخدمة الأهداف السياسية والعسكرية. فالأسماء مثل "عمود السحاب"، و"سيوف داود"، و"مخلب نبي"، و"درع الشمال" ليست مجرد تسميات عابرة، بل أدوات رمزية تُستحضر من الموروث الأسطوري الديني لتبريرالعنف وإضفاء بعدٍ مقدس على الحرب. هذا التداخل بين العقيدة والأسطورة والسياسة يعكس رؤية صهيونية ترى في الصراع امتدادًا لمعركة توراتية أبدية بين "شعب الله المختار" وأعدائه. بهذه الطريقة يتحول الدين إلى غطاء أيديولوجي يبرر القتل والتدمير بوصفهما "واجبًا مقدسًا"، ويمنح الجنود شعورًا بالرسالة الإلهية. إن هذا الاستخدام المنهجي للرموز الدينية يكشف البعد الميثولوجي في سلوك جيش الاحتلال، الذي يجد في النصوص القديمة شرعيةً دائمة لممارساته الحديثة.
وعند الحديث عن "طهارة السلاح"!! لا بد من النظر إلى جذور العنف الأولى. مجازر مثل ما حدث في دير ياسين في أبريل 1948، حين راح عدد كبير من سكان القرية ضحية هجوم نفذته مجموعات مسلحة صهيونية، تظل ذكرى لا تمحى في الذاكرة الفلسطينية والعربية، وتذكّر أن العمليات العنيفة ضد المدنيين كانت جزءًا من عملية تأسيس إسرائيل وليس شذوذاً منفصلاً. هكذا الأحداث تشكّل خلفية تاريخية لا يمكن تجاوزها عند تقييم أخلاقية المؤسسة العسكرية بالاعتماد على شعاراتها.
إن التاريخ لا يتوقف عند 1948؛ لقد تكرّست أنماط مماثلة عبر الحروب والعمليات العسكرية المتعاقبة. عدد الضحايا المدنيين في الحرب على غزة، يكشف عن واقع مغاير تمامًا لأسطورة "الجيش الأكثر أخلاقية في العالم". سجلات منظمات الأمم المتحدة والمنظمات الإنسانية تُظهر أعدادًا هائلة من القتلى والجرحى المدنيين، ونسبًا مرتفعة من النساء والأطفال بين الضحايا، ما يطرح سؤالًا صارخًا عن فعالية مبدأ التمييز بين مقاتلين وغير مقاتلين في الممارسات الميدانية. إن تكرار قصص الدمار والهلاك ضمن أحياء مأهولة ومدارس ومستشفيات يوضح أن الاستهداف ليس مجرّد أخطاء عسكرية معزولة، بل نمطًا يشي بسياسة قتالية إنتقامية مدمره تستهدف المدنيين الفلسطينيين..
وإحدى أوجه التفنيد الواضحة لأسطورة "طهارة السلاح" هو تدمير البنى التحتية المدنية على نطاق واسع. القصف المنهجي للمنازل والمستشفيات والمدارس والمساجد والجامعات ومخيمات اللاجئين لا يمكن تفسيره دائمًا ضمن حدود "الضرورة العسكرية". عندما تتحول الأحياء والمدن إلى ساحات معارك ويُستهدف فيها ما يفترض أن يكون محميًا بمقتضى القانون الدولي، تصبح العبارة الجوفاء عن "الامتناع عن استهداف المدنيين" غير مجدية أمام واقع احتلالي يعيد تشكيل الحيز المدني بأسره. تقارير الأمم المتحدة والمنظمات الطبية الدولية لا تتحدث عن أضرار عابرة فحسب، بل عن انهيار أنظمة صحية وتعطل خدمات أساسية وتهجير جماعي، وهي مؤشرات ملموسة على أن السلاح الذي يُزعم أنه "طاهر" يسبب أوسع قدر ممكن من المعاناة البشرية.
إن الصوت الرسمي والسلوك العملي يسيران أحيانًا في اتجاه معاكس منطق "الطهارة". تصريحات وتصرفات لمسؤولين وبعض عناصر المؤسسة العسكرية، من دعوات إلى "إخلاء" غزة بكاملها وتهجير سكانها، ومطالبات باستخدام وسائل تطهيرعرقي وصلت الى حد الحديث عن الخيار النووي في فضاءات معينة، كل هذا يضع علامة استفهام على الإدعاءات الأخلاقية التي ترددها إسرائيل. حين يُطلب من سكان محاصرين ترك منازلهم دون بدائل حقيقية، أو تُستخدم لغة تشير إلى تجريد الآخر من إنسانيته، تصبح "أخلاقيات" السلاح مجرد نصوص شكلية لا تقف أمام قرارات سياسية وميدانية تقرّب صورة السلاح الدموي من واقع الحياة اليومية للفلسطينيين.
الاستناد إلى أسطورة "طهارة السلاح" يخدم أيضًا وظيفة داخلية: تهدئة الضمير الجمعي للمجتمع الذي يتعرض لحملات تجنيد وتعبئة، وتقديم المؤسسة العسكرية كحارس "أخلاقي" لإسرائيل. لكنها، في الوقت نفسه، تعمل كآلية إنكار للنتائج المباشرة لإستراتيجيات الأمن القومي التي تختار العنف كأداة مركزية. النقد الذي يطرح نفسه هنا ليس دعوة لتبني معايير مزدوجة، بل مطلب للصدق الأخلاقي: إذا كانت القيم الدولية لتمييز المدنيين وحماية الأبرياء مهمة، فيجب أن تنعكس بالفعل في قواعد الاشتباك، في محاسبة من يخرقها، وفي سياسات تقلل من تعرض المدنيين للخطر بدل أن تزيده. إن استمرار الإفلات من العقاب أو التحول إلى روايات تفسيرية توضح أن الضحايا "ثمن لا مفرّ منه" لتأمين أهداف عسكرية، يضرب أسس أي ادعاء بوجود "طهارة" في السلاح المستخدم.
وفي مزيد من السقوط الأخلاقي كشفت قضية المدعيّة العسكرية "يفعات تومر يروشلمي" التي هزّت المؤسسة القضائية والعسكرية الإسرائيلية مؤخرا عن الوجه الحقيقي لجيش الاحتلال، لا كقوة تدّعي “طهارة السلاح” فقط، بل كجهاز ينهار أخلاقياً من الداخل، وذلك عندما سربت "يروشلمي" مقطع فيديو التقطته كاميرات المراقبة في قاعدة "سديه تيمان" العسكرية جنوب إسرائيل، يُظهر جنوداً من وحدة "القوة 100" وهم يعتدون جنسياً على معتقل فلسطيني مكبل اليدين. وبدلاً من محاسبة الجنود، تحوّلت القضية ضد من كشفت الجريمة (رغم أن المدعية العسكرية لم تكن متعاطفة مع الفلسطينيين وانما كان هدفها الحفاظ على انفاذ القانون كما صرحت). إذ تم إقالة يروشلمي واحتجازها والتحقيق معها بتهمة “تسريب معلومات أمنية حساسة”، في مشهد يعكس نظاماً يخاف الفضيحة أكثر من الجريمة نفسها.
إن منظمات حقوق الإنسان الدولية بإمكانها أن تفند أسطورة "طهارة السلاح" الإسرائيلية عبر تحويلها إلى أداة إدانة قانونية وأخلاقية، من خلال توثيق الجرائم الممنهجة ضد المدنيين الفلسطينيين وتحليلها في ضوء القانون الدولي الإنساني واتفاقيات جنيف. فشعار “الطهارة” ينهار أمام الأدلة المصورة والميدانية التي تثبت الاستهداف المتعمد للمدنيين، والمجازر في قطاع غزة والضفة الغربية، واستخدام أسلحة محرمة دوليًا. ويمكن لتلك المنظمات أن تقدم هذا التناقض بين الخطاب الأخلاقي المزور والممارسة الدموية كقرينة على الطابع العنصري والعقابي لجيش الإحتلال الإسرائيلي، تمهيدًا لإحالته إلى المحكمة الجنائية الدولية ولمزيد من الإدانة أمام الرأي العام العالمي.